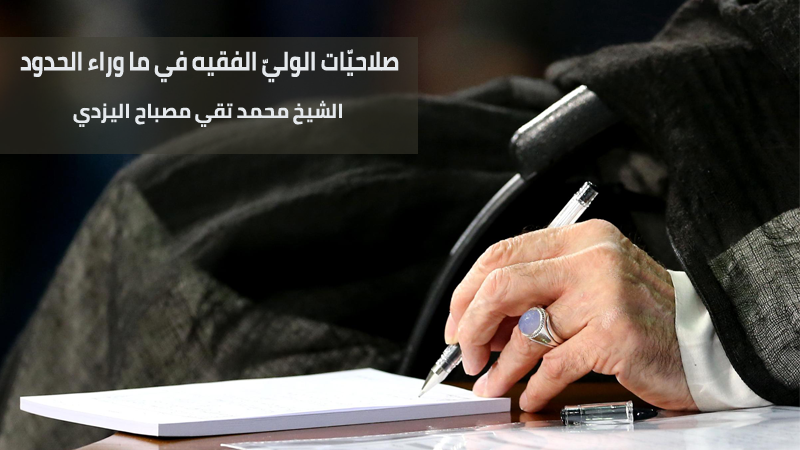آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
مقدّمة
بالنظر إلى أنّ مسألة «صلاحيّات الوليّ الفقيه في ما وراء حدود البلد الذي يخضع لولايته» تأتي ـ من حيث الترتيب المنطقيّ ـ في أواخر سلسلة المسائل المتّصلة بالحكومة الإسلاميّة وولاية الفقيه، وإنّ الإجابة عليها تتوقّف، إلى حدّ كبير، على حلّ المسائل السابقة لها والمباني والنظريّات التي يتمّ تثبيتها في المراحل المتقدّمة عليها، فإنّ من الضروريّ في البدء إلقاء الضوء على مجموعة المسائل التي تسبقها من حيث الترتيب.
قبل الدخول في المسائل السابقة على هذا البحث والمطلوبة كمقدّمة له نرى من الضروريّ تناول عنوان هذا البحث بمزيد من الدقّة. يشير العنوان المذكور إلى أنّنا ـ وقبل طرح هذه المسألة على بساط البحث ـ قد افترضنا وجود مجتمع أو بلد إسلاميّ ضمن حدود جغرافيّة ثابتة يُدار بواسطة نظام حكوميّ خاصّ باسم «ولاية الفقيه» وإنّ الأوامر الحكومتيّة لهذا «الوليّ الفقيه» نافذة على الأقلّ على الأشخاص الذين يعيشون ضمن هذه الحدود وقد بايعوه على الطاعة. بعبارة اُخرى؛ إنّ حديثنا يدور على أساس أنّ أصل ولاية الفقيه، ومشروعيّة النظام الذي يُدار بواسطتها، ونفوذ حكم الوليّ الفقيه ـ الذي وصل إلى سدّة الحكم في ظروف خاصّة ـ على الناس الذين بايعوه والذين يقطنون في البلد المذكور، هي أمور مُسبقة التحقّق وقد تمّ إثباتها بالدليل أو الأدلّة المقبولة. بعد حلّ هذه المسألة، نطرح فيما يلي بعض المسائل المتعلّقة بها والتي تحتاج أيضاً إلى الحلّ والتوضيح:
1. هل من الواجب على الفرد المسلم أو الجماعة المسلمة ممّن يعيش في بلد غير إسلاميّ (يقع خارج نطاق البلد الإسلاميّ المفترض والذي يُدار بنظام ولاية الفقيه) إطاعة الأوامر الحكومتيّة للفقيه المشار إليه أم لا؟
كما هو مُلاحظ فإنّ السؤال المذكور يحتمل فرضين؛ الأوّل: أنّ المسلمين الذين يعيشون خارج حدود البلد الإسلاميّ قد بايعوا الوليّ الفقيه، والثاني: أنّهم لم يبايعوه.
2. لو كان هناك بلدين إسلاميّين استقبل الناس في أحدهما نظام حكم ولاية الفقيه وبايعوا الفقيه الجامع للشرائط المتصدّي للحكم فيه، إلاّ أنّ الثاني يُدار بنظام حكم آخر، فهل يجب على سكّان البلد الثاني إطاعة هذا الوليّ الفقيه أم لا؟
هنا أيضاً يمكن تصوّر الفرضين المذكورين أعلاه وهما مبايعة أو عدم مبايعة الفرد المسلم أو المجموعة من المسلمين في البلد الثاني لهذا الفقيه.
3. لو استجاب بلدان إسلاميّان لنظام الحكم بواسطة ولاية الفقيه، إلاّ أنّ كلاًّ من شعبي البلدين عيّن فقيهاً هو غير ذاك الذي في البلد الآخر، أو أنّ ذوي الخبرة (مجلس الخبراء) في كلٍّ من البلدين صوّتوا لفقيه مختلف. ففي تلك الحالة هل حكم أيّ من هذين الفقيهين المفترضين نافذ فقط ضمن إطار ولايته أم هو شاملٌ لسكّان البلد الآخر، أم لابدّ من القول بالتفصيل في مثل هذه الحالات؟
هنا على الرغم من افتراض أنّ أهل كلّ بلد قد بايعوا فقيهاً خاصّاً، إلاّ أنّ احتماليّة أنّ بعض الأفراد في أيّ من البلدين قد بايعوا الفقيه الحاكم في البلد الآخر تبقى واردة، على هذا يبقى نفس الفرضين المتصوّرين في المسائل السابقة قائمين هنا أيضاً بشكل من الأشكال.
ممّا يجدر الالتفات إليه هنا أنّه في المسألتين الأخيرتين (2 و 3) قد تمّ افتراض وجود بلدين إسلاميّين مستقلّين وفي المسألة الأخيرة (3) كان الافتراض قائماً على مشروعيّة تعدّد الوليّ الفقيه في منطقتين جغرافيّتين متجاورتين أو غير متجاورتين.
4. لو أنّ أشخاصاً يعيشون ضمن حدود البلد المحكوم بنظام ولاية الفقيه لم يبايعوا الوليّ الفقيه لأيّ سبب كان، فهل إنّ أوامره الحكومتيّة نافذة عليهم أيضاً أم لا؟
من أجل الإجابة على هذا السؤال وبيان أبعاد المسألة يتعيّن علينا ـ من جانب ـ مناقشة قضيّة تعيين حدود البلد الإسلاميّ مع البلد الغير الإسلاميّ أو مع البلد الإسلاميّ الآخر، والأخذ بنظر الاعتبار مسألة تعدّد الحكومات الإسلاميّة أو البلدان الإسلاميّة. و من جانب آخر علينا إعادة النظر في أدلّة اعتبار ولاية الفقيه كي نقف على مدى شموليّتها للنقاط مورد السؤال، وفي غضون ذلك نحدّد دور البيعة في اعتبار ولاية الفقيه ليتّضح لدينا مدى تأثير بيعة بعض الأشخاص من عدمها على وجوب إطاعتهم للوليّ الفقيه.
■ وحدة البلدان وتعدّدها
هناك بحوث مستفيضة وآراء ونظريّات مختلفة حول قضيّة ظهور وتكوّن الشعوب والبلدان وعوامل انفصالها واتّحادها. كما إنّ مسائل من قبيل الملاك في مواطنة الأفراد بالنسبة لبلدٍ ما وأقسامه المختلفة، كالمواطنة الأصليّة والمكتسبة والمواطنة بالتبعيّة وكيفيّة الخروج عن المواطنة إجباراً أو اختياراً، هي من الأمور المبحوثة بشكل مسهب ومفصّل. ما نودّ أن نشير إليه باختصار هنا هو: إنّه ليس باستطاعة عوامل من قبيل اتصال الأرض ووحدتها أو وحدة اللغة واللهجة أو وحدة العنصر والدم أن تشكّل العامل المحدّد لوحدة شعب أو بلد. كما إنّ وجود الحدود الطبيعيّة كالجبال والبحار أو اختلاف اللغة واللهجة أو التباين في الدم واللون لا يمكنها أن تكون سبباً قطعيّاً لتعدّد وتمايز الشعوب والبلدان، بل وحتّى إنّ مجموع هذه العوامل معاً ليس لها تأثيراً نهائيّاً؛ أي إنّه من الممكن لمجموعة من الناس الذين يشتركون في الأرض واللغة والعنصر أن يشكّلوا بلدين مستقلّين عن بعضهما، كما إنّ من الممكن لمجموعة من البشر أن يكوّنوا بلداً واحداً بالرغم من وجود حدود طبيعيّة تفصلهم واختلافهم باللغة والعنصر، وهناك من هذه النماذج في عالم اليوم الكثير. بالطبع إنّ كلاًّ من العوامل المذكورة له تأثير بشكل أو بآخر على ارتباط البشر فيما بينهم وإيجاد الأرضيّة لوحدة الشعب والبلد، إلاّ أنّ العامل الأشدّ تأثيراً هو الاتّفاق في الرؤا والميول والنزعات التي تبعث على وحدة الحكومة، وإنّ العوامل الأخرى بالنسبة للعامل الأخير هي مجرّد عوامل مساعدة وناقصة وقابلة للتغيير.
إنّ العامل الأساسيّ لوحدة الأمّة والمجتمع الإسلاميّ، في نظر الإسلام، هو وحدة العقيدة. بيد أنّه لابدّ من الالتفات هنا إلى أنّ وحدة الأرض ووجود الحدود الجغرافيّة ـ الطبيعيّة منها والمصطنعة ـ ليست بعديمة التأثير كلّياً؛ فإنّنا نعلم ـ من جانب ـ أنّ «دار الإسلام»، التي تُحدّ طبعاً بحدود معيّنة، لها أحكام خاصّة في الفقه الإسلاميّ. فالهجرة إليها تصبح واجبة أحياناً، والذمّي الذي يتفلّت من أحكام الذمّة يُصار إلى إخراجه منها، وهكذا. ومن جانب آخر، إنّ الاختلاف في العقيدة ليس سبباً قطعيّاً لصيرورة الشخص أجنبيّاً عن الوطن تماماً، فمن الممكن أن يعيش غير المسلمين ضمن حدود الدولة الإسلاميّة و تحت حماية الحكومة الإسلاميّة، وأن يكون لهم، نتيجة لذلك، نوع من أنواع المواطنة.
محصّلة ذلك؛ إنّ المجتمع الإسلاميّ يتشكّل أساساً من مجموعة أفراد قد قبلوا الإسلام باختيارهم والتزموا بقوانينه الاجتماعيّة والقضائيّة والسياسيّة، وإنّ الأرض التي يعيش عليها هذا المجتمع تسمّى بالدولة الإسلاميّة أو «دار الإسلام». إلاّ أنّه في المرحلة التالية من الممكن لبعض غير المسلمين أن يحصلوا على حقّ المواطنة في الدولة أو البلد الإسلاميّ عبر إمضاء عقد معيّن يستطيعون من خلاله العيش بأمن وسلام جنباً الى جنب مع المسلمين.
بهذه الطريقة يتمّ تعيين الحدود ما بين البلد الإسلاميّ والبلدان غير الإسلاميّة؛ بمعنى: أنّ الأرض التي يعيش عليها أتباع الحكومة الإسلاميّة تُعرف ب «دار الإسلام» وإنّ حدود أملاك هؤلاء (مع توابعها ولواحقها) ستشكّل «حدود دار الإسلام»، بصرف النظر عمّا إذا حُدّدت معالمها بالعوامل الطبيعيّة كالجبال والبحار أو من خلال اصطناعها عبر الاتّفاقيّات المشتركة.
نستنتج إجمالاً ممّا تقدّم أنّ الملاك في وحدة وتعدّد الدول هو وحدة وتعدّد حكوماتها. فكلّ مجموعة من الناس تتمّ إدارة شؤونهم بنظام حكومة واحد يعتبرون أصحاب بلد واحد. وعلى العكس؛ فانّ تعدّد الأنظمة الحكوميّة المستقلّة في عرض بعضها البعض علامة على تعدّد الدول. بالطبع إنّ من الممكن أن يكون لكلّ مدينة أو ولاية نوع من الحكم الذاتيّ، غير أنّه لو كان لمجموع تلك الولايات دستور واحد، وكانت تحت مظلّة نظام حكوميّ مركزيّ واحد، وكانت تتبع الحكومة المركزيّة في قراراتها المتّخذة بخصوص السياسة الخارجيّة والدفاعيّة وما إلى ذلك (كما هو الحال في الدول الفدراليّة)، فانّها تعتبر دولة واحدة، وإنّ تعدّد الحكومات الغير المستقلّة فيها لا يقدح بوحدتها.
لكنّ العامل الذي يتمتّع ـ من الناحية العمليّة ـ بدور فاعل في تعيين حدود الدول، ووحدة و تعدّد الحكومات، واتّصالها واتّحادها معاً أو انفصالها وتجزّؤها عن بعضها هو ـ في الأعمّ الأغلب ـ «قوّة السلاح»، وممّا يؤسف له أنّ هذا العامل قد وجد طريقه إلى العالم الإسلاميّ أيضاً، وإنّ الحروب الداخليّة التي نشبت بين المسلمين، والتي أدّت إلى ظهور أو انقراض سلسلة من الإمارات والسلطنات في الأراضي الإسلاميّة، لشاهد ناطق على مثل هذه الحقيقة التاريخيّة المرّة. بطبيعة الحال إنّ ما يهمّنا هنا هو مناقشة هذه القضيّة من الناحية الفقهيّة، الأمر الذي يدفعنا الى أن نلقي نظرة خاطفة على آراء الفقهاء في هذا المضمار.
■ تعدّد البلدان حسب الرؤية الفقهيّة
طبقاً لما سبق ذكره فإنّ «دار الإسلام» هي عبارة عن الأرض أو الأراضي التي تعيش عليها الأمّة الإسلاميّة، ويمكن لغير المسلمين كذلك ـ وفق شروط خاصّة ـ العيش فيها بشكل آمن وسلميّ تحت ظلّ الحكومة الإسلاميّة، وإنّ حدود هذا البلد ـ سواءً الطبيعيّة منها أو المصطنعة ـ تسمّى ب «حدود دار الإسلام».
أمّا فيما يخصّ مسألة: هل إنّ دار الإسلام قابلة للتجزئة إلى عدّة دويلات مستقلّة بشكل كامل؟ فهذا ما لم يبحثه القدماء، على الرغم من أنّ سياق كلامهم يدور حول «الدولة الإسلاميّة الواحدة» التي تخضع للسلطة العليا ل «الإمام الواحد» وعندما كانت تظهر عدّة أنظمة حكوميّة كان يدّعي كلّ من قادتها أنّه هو «الخليفة الحقّ» وكان يخَطّئ الباقين ويعتبرهم «بُغاة». لكنّنا نستطيع القول أنّ كلام أغلب الفقهاء ناظر إلى ظروف خاصّة وليسوا ـ بشكل عامّ ـ بصدد نفي المشروعيّة عن الحكومات المتعدّدة. ولعلّ من الممكن الاستنتاج، من إطلاق بعض الأقوال في تعيين شرائط الإمام، بل وفي بعض التصريحات، أنّّهم لا يعتبرون وجود حكومتين في منطقتين منفصلتين ـ على فرض استيفاء مسؤوليهما للشروط ـ أمراً غير مشروع، لاسيّما وأنّ معظم كبار أهل السنّة (أمثال أحمد بن حنبل) يرون أن حكومة الفاسق وشارب الخمر، الذي تسلّط على رقاب الناس بالقوّة، مشروعة وأنّه مفروض الطاعة!
إلاّ أنّ فقهاء الشيعة يجمعون على أنّ الحكومة الإسلاميّة بعد رحيل رسول الله(ص) هي، أصالةً، من شؤون الإمام المعصوم(ع) وينفون الإمامة بالفعل لإمامين معصومين في آنٍ واحد حتّى و إن كان أحدهما ـ فرضاً ـ في شرق الأرض والآخر في غربها. بعبارة اُخرى؛ إنّ عقيدة التشيُّع هي أنّه لابدّ لدار الإسلام برمّتها أن تكون تحت قيادة وإمامة إمامٍ معصوم واحد وإنّ حكّام كلّ منطقة يُنَصّبون ويُعَيّنون من قِبَله، والكلّ ـ طبعاً ـ هو في مقام المنفّذ للقانون الإسلاميّ وأوامر الإمام المعصوم، وإن كان كلّ منهم مفوّض من قبل المعصوم ببعض الصلاحيّات ضمن نطاق حكومته ممّا يتيح له تصويب وتنفيذ قوانين ومقرّرات خاصّة في إطار القانون الإسلاميّ العامّ وحسب ما تقتضيه مصالح المسلمين والظروف الزمانيّة والمكانيّة. بناءً على هذا، يمكن قبول نوع من أنواع الحكم الذاتيّ في الأقاليم المختلفة لدار الإسلام. بالطبع كلّ هذا إنّما يصحّ في حال كون الإمام المعصوم مبسوط اليد ويمتلك القدرة الظاهريّة على الإمساك بزمام الأُمور؛ أي إنّ حكومته الشرعيّة هي محطّ قبول الناس أيضاً. إلاّ أنّنا نعلم أنّ مثل هذه الظروف لم تتوفّر إلاّ لفترة وجيزة من أيّام إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب والإمام الحسن(ع)، وإنّ باقي الأئمّة الطاهرين(ع) ليس فقط لم يتصدّوا لإدارة شؤون البلاد الإسلاميّة، بل لم يكن ليُسمح لهم حتّى إبداء الرأي في مثل تلك المسائل، وكانوا غالباً إمّا تحت المراقبة الشديدة أو في المنفى أو في غياهب الطوامير والسجون، ولم يكونوا يبوحوا بمثل تلك الأمور إلاّ للخواصّ من أصحابهم موصين إيّاهم بكتمانها.
لهذا فإنّ الشيعة ـ الذين حُرموا من بركات حكومة أئمّة أهل البيت(ع) من جهة، ولم يكونوا يقولون بأيّ مشروعيّة للحكومات التي حكمت آنذاك من جهة اُخرى ـ قد وقعوا في ضيق وحرج شديدين الأمر الذي دفعهم، وفقاً للتعاليم التي وردت في بعض الروايات (كمقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة)، إلى السعي إلى تأمين بعض حوائجهم الحكومتيّة ـ لاسيّما القضائيّة منها ـ عبر الرجوع إلى الفقهاء الواجدين للشرائط. وقد جاء التأكيد في بعض تلك الروايات على أنّ مخالفة هؤلاء الفقهاء هو بمنزلة مخالفة الإمام المعصوم ممّا يُعدّ ضرباً من ضروب الشرك بالله تعالى!
على المنوال نفسه كانت المتطلّبات الحكومتيّة للاقليّات الشيعيّة في زمان الغيبة تُسَدّ من خلال الرجوع سِرّاً إلى الفقهاء الجامعين للشرائط ممّا أدّى إلى حصول الشيعة في بعض المناطق على سلطة لا بأس بها، نذكر منهم ـ على سبيل المثال ـ الفاطميّون الذين نجحوا في تشكيل حكومة مستقلّة في مصر، وحكّام الديلم وآل بويه الذين أمسكوا بزمام الحكم في بعض مناطق إيران بل وألقت حكومتهم بظلالها على خلافة الدولة العبّاسيّة التي كانت تعاني آنذاك من مرحلة اُفول وانحطاط، فآلت الأمور بالنتيجة إلى قيام الدولة القويّة للصفويّين في إيران لتكون الندّ والمنافس فيما بعد لنظام الخلافة العثمانيّة.
إنّه في مثل تلك الأحوال والظروف وجد الفقهاء الشيعة الفرصة مناسبة لطرح بحوثهم الفقهيّة حول الحكومة الإسلاميّة وانبروا علناً لنقد نظريّات وآراء فقهاء أهل السنّة وتبيين الرؤية الشيعيّة المبنيّة على مبدأ ولاية الفقيه.
نحن هنا لسنا بصدد البحث بشكل تفصيليّ في نظريّة ولاية الفقيه واُصولها ومبانيها وفروعها ولوازمها، إلاّ أنّه، وكما أشرنا في مقدّمة البحث، من أجل الإجابة على الأسئلة المطروحة لابدّ من إلقاء نظرة على نظريّات الفقهاء وأدلّتهم في هذه المسألة، وهذا المطلب ـ في الحقيقة ـ يشكّل أهمّ أقسام هذه المقالة.
■ مباني ولاية الفقيه
تأسيساً على ما ذُكر فإنّ الشيعة ـ عندما فقدوا الأمل في تشكيل الحكومة ـ كانوا يعمدون إلى تأمين متطلّباتهم اليوميّة في هذا المجال بالرجوع إلى فقهاء البلاد، وفقاً لمرتكزاتهم الذهنيّة مستلهمين ذلك من أمثال روايات عمر بن حنظلة وأبي خديجة والتوقيع الصادر من الناحية المقدّسة، معتبرين ـ في الواقع ـ الفقهاء الجامعين للشرائط «النوّاب العامّين لصاحب العصر» (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) في مقابل «النوّاب الخاصّين» له في زمان الغيبة الصغرى. ولكن منذ أن حصل بعض حكّام الشيعة على شيءٍ من السلطة طُرحت مسألة «ولاية الفقيه في زمان الغيبة الكبرى» بمزيد من الجديّة. وعند انتشار صيت هذه القضيّة بين عامّة الناس، سعى الحكّام والسلاطين، من أجل إضفاء الشرعيّة على حكوماتهم، إلى الحصول على موافقات الفقهاء الكبار بل وحتّى إلى الاستئذان منهم رسميّاً في بعض الأحيان، وفي المقابل اغتنم الفقهاء مثل هذه الفرصة لنشر العلوم الإسلاميّة والترويج للمذهب. إلاّ أنّ ظواهر الأمور تشير إلى أنّه لم يكن أيّ من هؤلاء السلاطين في أيّ من الأزمنة مستعدّاً لتسليم كرسيّ سلطنته إلى الفقيه الجامع للشرائط، كما إنّه لم يكن لأيّ فقيه الأمل في الوصول يوماً إلى سدّة الحكم. في الواقع إنّ انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران كان السبب من وراء تحقّق ولاية الفقيه عمليّاً بالمعنى الحقيقيّ للكلمة فبرزت الحاجة إلى دراسة مبانيها وفروعها بمزيد من الدقّة والتعمّق.
إنّ أهمّ سؤال يطرح بخصوص المباني هو: ما هو المناط في مشروعيّة ولاية الفقيه؟ وما هو الدليل على ذلك؟ إذ أنّ الإجابة بشكل واضح ودقيق على هذه الأسئلة كفيل بأن يُجيب على المسائل الفرعيّة التي من جملتها الأسئلة المطروحة في مستهلّ البحث.
في هذا الصدد يمكننا الإشارة إلى مبنيين أساسيّين:
المبنى الأوّل: إنّ مشروعيّة ولاية وحكومة الفقيه مستمدّة من الولاية التشريعيّة لله عزّ وجلّ، وإنّه أساساً ليس لأيّ ولاية أن تكتسب الشرعيّة من دون الاستناد الى النصب والإذن الإلهيّين، بل وإنّ اعتبار شرعيّة أيّ حكومة إن لم يكن عن هذا الطريق فهو نوع من الشرك في الربوبيّة التشريعيّة للباري جلّ وعلا. بتعبير آخر؛ إنّ الله تعالى قد أسند مقام الحكومة والولاية على الناس إلى الإمام المعصوم(ع) وإنّ الإمام هو من نصّب الفقيه المستوفي للشروط، سواءً في زمان الحضور وعدم بسط اليد أو في زمان الغيبة، وإنّ طاعته ـ في الحقيقة ـ طاعة للإمام المعصوم كما إنّ مخالفته مخالفة له وهي بمنزلة إنكار الولاية التشريعيّة الإلهيّة: «والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله».
المبنى الثاني: إنّ الشارع المقدّس لم يمنح حقّ الولاية إلاّ للإمام المعصوم، وبطبيعة الحالة إنّ اِعمال هذه الولاية لن يتسنّى له إلاّ في زمان حضوره(ع). أمّا في زمان الغيبة فيجب على الناس ـ استناداً إلى القواعد الكليّة، مثل «أوفوا بالعقود» و«المسلمون عند شروطهم» أو، أحياناً، عندما تتوفّر مثل هذه الادلّة ـ أن ينتخبوا ويبايعوا من يجدونه مناسباً للحكومة، نظير ما يعتقد به أهل السنّة في الحكومة بعد رحيل النبيّ الأكرم(ص). غاية ما في الأمر أنّ الشارع يبيّن شروط الحاكم الصالح وإنّ المسلمين مكلّفون أن يشترطوا في بيعتهم التزام الحاكم بالعمل وفقاً لتعاليم الإسلام. أمّا التعهّد بالطاعة المطلقة فهو بمثابة «الشرط المخالف للشرع ضمن العقد» ولا اعتبار له. على أساس هذا المبنى فإنّ المناط في مشروعيّة ولاية الفقيه هو عقد يُبرم مع الناس وإنّ البيعة ـ في الحقيقة ـ هي التي تلعب الدور الرئيس في إضفاء الشرعيّة على ولاية الفقيه.
على ما يبدو فإنّ المرتكز في أذهان الشيعة والمستفاد من كلام الفقهاء هو المبنى الأوّل، وإنّ التعابير الواردة في الروايات الشريفة تؤيّده بشكل كامل. أمّا الأمر الذي أدّى، في الواقع، إلى طرح النظريّة الثانية هو إمّا الانجذاب نحو الديمقراطيّة الغربيّة الذي وجد ـ مع بالغ الأسف ـ طريقه إلى الدول الإسلاميّة أيضاً، أو إنّه بيان الدليل الجدليّ من أجل إقناع المخالفين وإلزامهم، كما ورد في كلام أمير المؤمنين(ع) الذي خاطب فيه معاوية في قضيّة اعتبار بيعة المهاجرين والأنصار.
على أيّة حال إنّنا سنناقش المسائل المطروحة على أساس كلا المبنيين. ولكن قبل الدخول في هذا الموضوع لنحاول توضيح أصل نظريّة ولاية الفقيه ومفاد أدلّتها.
■ أدلّة ولاية الفقيه
تقسم أدلّة إثبات ولاية الفقيه الجامع للشرائط إلى قسمين أساسيّين: عقليّ ونقليّ.
ـ الأدلّة العقليّة: نظراً إلى ضرورة وجود الحكومة لتأمين المتطلّبات الاجتماعيّة للرعيّة والوقوف أمام الهرج والمرج والفساد والإخلال بالنظام، وبالالتفات إلى أهميّة تنفيذ الأحكام الاجتماعيّة للإسلام وعدم اختصاص تلك الأحكام بزمان حضور النبيّ(ص) والأئمّة(ع)، يمكن إثبات ولاية الفقيه من طريقين:
الأوّل: هو أنّه عندما لا يتيسّر تحصيل المصلحة التي يكون استيفاؤها بالحدّ المطلوب والمثاليّ ضروريّاً فلابدّ من تأمين هذه المصلحة بنسبة هي أقرب ما تكون الى الحدّ المطلوب. إذن ففي مسألتنا هذه لو كان الناس محرومين من مصالح حكومة الإمام المعصوم لَتعيّن عليهم السعي إلى تحصيل المرتبة التالية لذلك؛ بمعنى أن يرضوا بحكومة شخص هو أقرب ما يكون إلى الإمام المعصوم. هذا القرب يتبلور في ثلاثة أمور أساسيّة: أوّلها: العلم بالأحكام الكليّة للإسلام (الفقاهة)، وثانيها: اللياقة الروحيّة والأخلاقيّة التي تردعه عن الانجراف خلف أهواء النفس أو الوقوع فريسة للتهديد والتطميع (التقوى)، وثالثها: الجدارة والخبرة في إدارة شؤون المجتمع التي يمكن تفكيكها إلى خصال ثانويّة من قبيل: الوعي السياسيّ والاجتماعيّ، والوقوف على القضايا الدوليّة، والشجاعة في التصدّي للأعداء والمخرّبين، والحدس الصائب في تشخيص الأولويّات والأهمّ فالأهمّ، و... الخ. إذن يتوجّب على الشخص الذي يتمتّع أكثر من غيره بمثل هذه المواصفات أن يتولّى زعامة وقيادة المجتمع ليجمع أركان الدولة إلى بعضها ويسير بالبلاد نحو الكمال المطلوب. بالطبع إنّ مهمّة تشخيص مثل هذا الشخص لابدّ أن يُعهد بها إلى ذوي الخبرة كما هو المعمول به في كلّ مرافق الحياة الاجتماعيّة الأخرى.
الطريق الثاني: إنّ الولاية على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم هي من شؤون الربوبيّة الإلهيّة ولا تستمدّ شرعيّتها إلاّ من خلال التنصيب من قبل الله أو الإذن منه تعالى، وإنّنا نعتقد أنّ هذه السلطة القانونيّة قد اُسند بها إلى النبيّ الأكرم(ص) والأئمّة المعصومين(ع) من بعده. لكن في الزمن الذي يكون الناس فيه محرومين عمليّاً من وجود القائد المعصوم فهل على الله سبحانه وتعالى أن يصرف النظر عن تنفيذ الأحكام الاجتماعيّة للإسلام؟ أم أن يأذن لمن هو أصلح من الآخرين لتولّي هذه المهمّة لئلاّ يستلزم الترك ترجيح المرجوح ونقض الغرض والعمل بخلاف الحكمة؟ ونظراً لبطلان الفرض الأوّل يثبت الثاني؛ وهذا يعني أنّنا نكتشف من طريق العقل أنّ هذا الإذن قد صدر من قبل الله تعالى والأولياء المعصومين حتّى وإن لم يقع في ايدينا بيان نقليّ صريح بذلك. والفقيه الجامع للشرائط هنا هو ذاك الفرد الأصلح حيث أنّه عارف بأحكام الإسلام أفضل من غيره، ويتمتّع بضمانة أخلاقيّة أقوى من أجل تنفيذ هذه الأحكام، وفي الوقت ذاته هو الأجدر والأكثر كفاءة في مقام تأمين مصالح المجتمع وتدبير شؤون الرعيّة. إذن فنحن نكشف عن مشروعيّة ولايته (الفقيه) عن طريق العقل، كما هو الحال في الكثير من الأحكام الفقهيّة الأخرى، لاسيّما في حقل المسائل الاجتماعيّة (كالواجبات الحربيّة) حيث يجري إثباتها عن هذا الطريق (الدليل العقليّ).
ـ الأدلّة النقليّة: وهي عبارة عن الروايات الدالّة على إرجاع الناس إلى الفقهاء في سبيل قضاء حوائجهم الحكومتيّة (خصوصاً فيما يتعلّق بمسائل القضاء والمنازعات)، أو تلك التي تعرّف الفقهاء على أنّهم «الأمناء» أو «الخلفاء» أو «وارثي» الأنبياء وأنّهم الأفراد الذين بيدهم مجريات الأمور، وقد اُغرق في البحث في سندها ودلالتها ممّا لا يسع المقام هنا لذكره، وما على الراغب إلاّ الرجوع الى الكتب والرسائل المفصّلة في هذا المضمار.
إنّ الأفضل ـ من بين تلك الروايات ـ في الاستناد عليه هي مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة والتوقيع الشريف، فليس من سبيل للتّشكيك في سندها حيث أنّها تتمتّع بشهرة روائيّة وفتوائيّة، وإنّ دلالتها على تنصيب الفقهاء بعنوانهم وكلاء وممثّلي الإمام المقبوض اليد لواضحة. وإن لم تكن الحاجة الى مثل هذا التنصيب في زمان الغيبة أشدّ منها في زمان الحضور، فهي ليست بالأقلّ منها. إذن، وفقاً ل «الدلالة المطابقية» يثبت أيضاً تنصيب الفقيه في زمان الغيبة. كما أنّ احتماليّة أنّ تعيين وليّ الأمر في زمان الغيبة قد اُوكل إلى الناس أنفسهم، فعلاوة على عدم توفّر أدنى دليل على هذا التفويض، فإنّه لا ينسجم والتوحيد في الربوبيّة التشريعيّة، ولم يتمّ طرح ذلك ـ حتّى من باب الاحتمال ـ من قِبل أيّ فقيه من الشيعة (اللّهم إلاّ في الآونة الأخيرة). على أيّة حال فإنّ الروايات المذكورة أعلاه تُعدّ من المؤيّدات الممتازة للأدلّة العقليّة.
طبقاً لهذا المبنى بات من الجليّ ضمناً أن لا دور للبيعة مطلقاً في شرعيّة ولاية الفقيه، كما لم يكن لها أيّ دور في شرعيّة حكومة الإمام المعصوم. إلاّ أنّ بيعة الناس للوليّ من شأنها أن تهيّئ الأرضيّة اللازمة لإعمال ولايته وإنّ وجودها سوف يسلب من حاكم الشرع العذر في الانزواء وعدم التصدّي لإدارة شؤون المجتمع: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر...».
هنا يُطرح السؤال التالي: بأيّ آليّة تمّ نصب الفقيه من قبل الله سبحانه وتعالى أو الإمام المعصوم؟ هل إنّ كلّ فرد جامع للشرائط يتمتّع بمقام الولاية بالفعل، أم إنّه شخص بعينه، أم إنّهم مجموعة فقهاء كلّ عصر وزمان؟ جواباً على ذلك نقول: إذا كان استنادنا أساساً على الدليل العقليّ، فمقتضاه واضح؛ ذلك لأنّ تنصيب الفقيه الذي هو الأفضل على صعيد الفقاهة والتقوى والقدرة الإداريّة ولوازمها، والذي يتمتّع بإمكانيّة إدارة شؤون جميع مسلمي العالم من خلال نصب الحكّام والعمّال المحلّيّين، هو أقرب إلى المشروع الأصليّ لحكومة الإمام المعصوم وهو أفضل في الوصول إلى الهدف الإلهيّ المتمثّل في وحدة الأمّة الإسلاميّة وحكومة العدل العالميّة. لكن في حال أنّ ظروف العالم لا تسمح بتشكيل هذه الدولة الواحدة، فلابدّ من التنزّل والتفكير بأشكال حكوميّة اُخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب. أمّا إذا كان استنادنا بالأصل على الروايات فإنّه، وإن كان مقتضى الإطلاق فيها هو ولاية أيّ فقيه جامع للشرائط، لكنّنا ـ نظراً لوجود الروايات التي تتضمّن التأكيد على تقديم الأعلم والأقوى(أمثال الحديث النبويّ المشهور وصحيحة عيص بن قاسم) ـ سنحصل على نفس النتيجة التي حصلنا عليها من خلال الأدلّة العقليّة.
السؤال الآخر الذي يُطرح هنا هو: لو لم يوجد الشخص الذي هو الأفضل من جميع الجوانب فما العمل؟ والجواب الإجماليّ على هذا السؤال هو: إنّ الشخص الذي يتّصف في المجموع ب «الأفضليّة النسبيّة» لابدّ أن يأخذ على عاتقه هذه المسؤوليّة، وعلى الناس أن يقبلوا بولايته. بالطبع إنّ التفرّعات المختلفة لهذه المسألة تحتاج إلى بحث مستفيض ومعمّق ممّا يتطلّب مجالاً أوسع.
■ النتيجة
حان الوقت الآن للعودة إلى الأسئلة التي طُرحت في مستهلّ البحث للإجابة عليها.
ـ السؤال الأوّل هو: إذا كان هناك بلد إسلاميّ واحد يخضع لولاية فقيهٍ ما فهل على المسلمين الذين يعيشون في البلدان الأخرى الغير الإسلاميّة أن يطيعوا أوامره ونواهيه الحكومتيّة أم لا؟ (هذا بالطبع إذا كانت أوامره تخصّهم).
إنّ الجواب على هذا السؤال ـ حسب المبنى الأوّل (أي ثبوت الولاية بتنصيب من الإمام المعصوم أو بالإذن منه) ـ واضح لأنّ الفرض القائم هو أنّ أفضليّة الفقيه المذكور، للتصدّي لمنصب الولاية، مُحرزة، وطبقاً للأدلّة العقليّة فإنّ مثل هذا الشخص له حقّ الولاية بالفعل على الناس. بناءً على هذا، فإنّ أوامره ستكون نافذة على كلّ مسلم؛ بمعنى أنّ إطاعته واجبة حتّى على المسلمين المقيمين في الدول الغير الإسلاميّة.
أمّا حسب المبنى الثاني (ألا وهو توقّف ولاية الفقيه بالفعل على انتخاب الناس و بيعتهم) فيمكن القول بأنّ انتخاب أكثريّة الأمّة أو أكثريّة أعضاء المجلس المتشكّل من أهل الحلّ والعقد هو حجّة على الآخرين أيضاً (كما هو الحال في عمل العقلاء و بنائهم، ولعلّه يُفهم ـ أيضاً ـ من بعض الخُطب الجدليّة لنهج البلاغة، بخصوص اعتبار بيعة المهاجرين والأنصار، ما يؤيّد هذا المعنى). لذا، طبقاً لهذا المبنى كذلك، فإنّ طاعة الوليّ الفقيه واجبة حتّى على المسلمين الذين يعيشون في البلدان غير الإسلاميّة بصرف النظر عمّا إذا كانوا قد بايعوه على الولاية أم لم يفعلوا.
لكن قد يُقال هنا: إنّ هذا الانتخاب أو هذه البيعة هي ليست سوى تفويض صلاحيّات شخص لآخر ضمن عقد مبرم، ومن هذا المنطلق فإنّ الطاعة للوليّ الفقيه تكون مفروضة على اُولئك الذين بايعوه فحسب وإنّ المسلمين ممّن يعيشون خارج البلاد، بل إنّ المسلمين الذين يقطنون في الداخل ممّن لم يبايعوه غير ملزمين شرعاً بالطاعة. بيد أنّ ذلك ـ وفقاً للبناء العامّ والدائميّ والمُسَلَّم به عند العقلاء ـ غير ثابت وغير مُسلَّم به، كما وإنّ الهدف من الخطاب الجدليّ ليس سوى إقناع الخصم وإلزامه [بما ألزم به نفسه].
ـ أمّا السؤال الثاني فهو: لو وُجد بلدان إسلاميّان وكان أحدهما فقط تحت حكم نظام ولاية الفقيه، فهل تجب إطاعة ذلك الفقيه على المسلمين الذين يعيشون في البلد الآخر أم لا؟
هنا الجواب مشابه للجواب السابق مع فارق بسيط وهو أنّه يمكن في هذه المسألة افتراض صيغة اُخرى نادرة وذلك أنّ المسلمين المقيمين في البلد الآخر يرون ـ من باب الاجتهاد أو التقليد ـ أنّ حكومتهم مشروعة وواجبة الطاعة حتّى وإن كانت تُدار بنظام حكوميّ آخر غير ولاية الفقيه. ففي هذه الحالة سيكون تكليفهم الظاهريّ هو إطاعة حكومتهم وليس الوليّ الفقيه الذي يحكم البلد الآخر.
ـ السؤال الثالث يقول: لو أنّ كلّ بلد من مجموع بلدين أو عدّة بلدان إسلاميّة قَبِِل بولاية فقيه خاصّ به، اَلا يسري حكم أيّ من هؤلاء الفقهاء على مواطني البلد أو البلدان الاخرى؟
الجواب على هذا السؤال يتطلّب تأمّلاً أكثر لأنّه أولاً: لابدّ من الافتراض بأنّ ولاية كلا الفقيهين (أو كلّ الفقهاء) مشروعة وأنّ أوامره نافذة وسارية في بلده ـ بالقدر المتيقّن ـ وذلك لأنّنا أشرنا سابقاً بأنّ وجود دولتين إسلاميّتين مستقلّتين تماماً بحكومتين شرعيّتين يمكن قبوله في حال كانت إمكانيّة تشكيل حكومة إسلاميّة واحدة غير متيسّرة على الإطلاق. أمّا افتراض أنّ ولاية أحد الفقيهين فقط هي المشروعة والمحرزة فهذا يرجعنا إلى المسألة السابقة. ثانياً: لابدّ من الافتراض أنّ أمر أحد الحكام الفقهاء على الأقلّ يخصّ المسلمين المتوطّنين في البلد الآخر وإلاّ فلن يكون معنى لنفوذ حكمه عليهم.
بالالتفات إلى الشرطين المذكورين في أعلاه، إذا أصدر أحد الفقهاء الحاكمين حكماً عامّاً بحيث يشمل حتّى المسلمين الساكنين في البلد الآخر التابع للوليّ الآخر، فسوف تتفرّع لهذه المسألة ثلاث صور على الأقلّ، مفادها: إنّ الحاكم الآخر إمّا أن يبادر إلى تأييد هذا الحكم، أو أن يعمد إلى نقضه، أو أن يختار السكوت مقابله.
فإن أيّد الحاكم الآخر هذا الحكم، فلا مجال للبحث فيه لأنّه سيكون بمثابة إصدار حكم مشابه من جهته ممّا سيكون واجب التنفيذ. أمّا في حالة نقضه للحكم المذكور ـ وبطبيعة الحال فإنّ النقض المعتبر هنا هو ذاك المستند إلى علمه ببطلان ملاك الحكم بشكل كلّيّ أو بطلانه بالنسبة لمواطني بلده ـ ففي هذه الحالة لن يكون للحكم المنقوض اعتبار بالنسبة لسكّان بلده إلاّ أن يتوفّر اليقين بأنّ النقض المذكور لم يكن في محلّه.
و في حالة سكوته مقابل الحكم، فبحسب المبنى الأوّل في اعتبار ولاية الفقيه (أي التنصيب من قبل الامام المعصوم) فإنّ إطاعته واجبة حتّى على باقي الفقهاء، كما هو الحال في اعتبار حكم أحد القضاة الشرعيّين حتّى بالنسبة للقاضي الآخر أو دائرة قضائه.
وأمّا طبقاً للمبنى الثاني فيتعيّن القول: أنّ حكم أيّ فقيه نافذ وساري المفعول فقط على أهل بلده (بل على الأشخاص الذين بايعوه فحسب) ولا اعتبار له بالنسبة للآخرين، وهنا لا يبقى مجال للتمسّك ببناء العقلاء المدّعى في المسألة السابقة.
ـ وفيما يخصّ الافتراض القائم على أنّ المسلمين المقيمين في بلد ما قد بايعوا الفقيه الحاكم في بلد آخر فهو ـ في الواقع ـ بمنزلة الخروج عن مواطنة البلد الذي يعيشون فيه والقبول بمواطنة البلد الذي بايعوا وليّ أمره. وهذه القضيّة لا تدخل ضمن إطار بحثنا في الوقت الحاضر.
المصدر: مجلة «حكومت إسلامي»، السنة الاُولى، العدد الأوّل، خريف عام 1996 م، ص 81 ـ 86.