
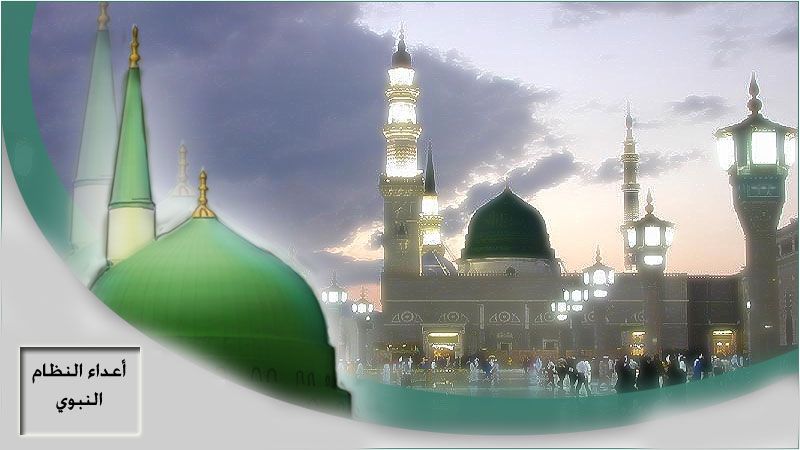
كان للنبي خمسة أصناف من الأعداء يتربصون بالمجتمع الإسلامي وهم عبارة عن:
العدوّ الأول:
وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود لكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس الوقت، إنه القبائل شبه الهمجية التي تحيط بالمدينة وجل حياتها عبارة عن تقاتل وإراقة للدماء وإغارة ونهب وسلب، وإذا كان النبي (ص) يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمنٍ ووادع في المدينة فما كان عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل (ص)، حيث تعاهد مع مَنْ تتوفر فيه إمارات الصلاح والهداية مع بقائهم على كفرهم وشركهم بغية تجنب تحرشاتهم. أما الذين كانت تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح ولا تستقر لهم حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهم النبي (ص) وقمعهم وأخمد نارهم.
العدوّ الثاني:
إن ثمة مجموعة من الأشراف المتكبرين العتاة المتنفذين كانت تحكم مكة، وهم على اختلافهم كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد، وكان الشعور يراود النبي (ص) بأنه لو توانى حتى يداهموه هم فإن الحظ سيحالفهم، لذلك فقد تتبعهم وقد اتسم تعامل النبي (ص) مع هذا العدو بالتدبير والاقتدار والتأني والصبر بعيداً عن الارتباك، ولم يتراجع أمامه ولو خطوة واحدة، بل كان يتقدم نحوه يوماً بعد يوم وآناً بعد آن.
العدوّ الثالث:
وهم اليهود؛ أي الدخلاء الغدرة الذين سرعان ما عبّروا عن استعدادهم لمعايشة النبي (ص) في المدينة لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي وذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس ويحوكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوب الناس ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدواً منظماً، فكان النبي (ص) يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه، لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم.
العدوّ الرابع:
وهم المنافقون في داخل المدينة من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وكانوا يتميزون بضيق الرؤية والقابلية على التعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظيم وهذا ما يميزهم عن اليهود.
العدوّ الخامس:
هو عبارة عن العدوّ الكامن في باطن كل مسلم ومؤمن وهو الأخطر من بين جميع الأعداء، وهذا العدو معشش فينا أيضاً، إنه الأهواء النفسية والأنانية والجنوح نحو الانحراف والضلال والانزلاق الذي يصطنعه الإنسان نفسه، وقد خاض النبي (ص) مع هذا العدو صراعاً مريراً، غاية الأمر أن آلة الصراع مع هذا العدو لا تتمثل بالسيف، بل التربية والتزكية والتعليم والتحذير. فلما عاد المسلمون من الحرب قال لهم الرسول (ص): مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فتعجب المسلمون من قوله وسألوه: ما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟! لقد خضنا غمار هذا الجهاد المرير، فهل من جهاد أكبر منه؟! قال: نعم، إنه جهاد النفس. فإذا ما صرح القرآن الكريم: {الذين في قلوبهم مرض} فذلك لا يعني أنهم منافقون، بل بعض المنافقين في عداد الذين في قلوبهم مرض، ولكن ليس كل «الذين في قلوبهم مرض» من المنافقين، فربما يكون المرء مؤمناً لكنه في قلبه مرض، فماذا يعني هذا المرض؟ إنه يعني ضعف الأخلاق والشخصية، والشهوانية والجنوح نحو مختلف الأهواء التي إن لم تبادر للحد منها ومقارعته،ا فإنها ستأتي على الإيمان من الداخل وستؤدي بالتالي إلى خوائك داخلياً، وإذا ما اُستلب الإيمان منك وخلا باطنك وظل الإيمان ملاصقاً لظاهرك، إذ ذاك ستدخل ضمن الذين يطلق عليهم اسم «المنافق».
فلو خلت قلوبنا أنا وأنتم من الإيمان وبقي ظاهرنا متلبساً بالإيمان، وقطعنا أواصر الإيمان وعلائقه، بيد أن ألسنتنا ظلت تلهج بالتعابير الإيمانية، فهذا هو النفاق وهو من الخطورة بمكان؛ والقرآن الكريم يصرح {ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله} (الروم: 10)، وذاك هو السوء المبين، ألا وهو التكذيب بآيات الله. ويقول في موضع آخر: {فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه} (التوبة: 77). وهذا هو مكمن الخطر الذي يتهدد المجتمع الإسلامي، وحيثما شاهدتم في التاريخ انحرافاً في المجتمع الإسلامي فإنه يمثل منطلق هذا الانحراف.
الإمام الخامنئي "دام ظله"